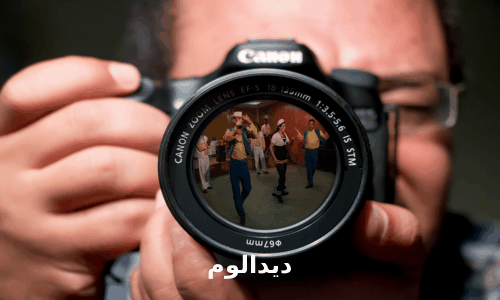مبدأيًا عندنا نسمي الطالب المجد المجتهد اللطيف (الكيوت) شاطرًا بينما الشاطر لغويًا واصطلاحيًا هو من أعيا أهله خبثًا ولؤمًا وعصا أباه أو ولي أمره وعاش في الخلاعة كما يقول الدكتور محمد رجب النجار في كتابه حكايات الشطار والعيارين في الوطن العربي، ويذكر المؤلف في نفس الكتاب أن قصص اللصوص نمطٌ شائع في الأدب العالمي، احتفى به التراث الأدبي العربي بشكل خاص فيما يعرف فنيًا باسم أدب الشطار العربي الذي يسهب في سرد قصص اللصوص من الصعاليك والشطار والعيارين والعياق والفتيان والزعار (جمع أزعر) والدعار والحرافيش.
كل هذه الأسماء تشير إلى اللصوصية والأعمال أو الأنشطة أو المهن المحتقرة، أي أنها تسِم أراذل الناس وإن كان معظمها أصبح مستخدمًا كنوع من الثناء؛ فعلى سبيل المثال العياق جمع عائق أو عايق هو قاطع الطريق ومنه جاء قولنا في العامية "عامل عَوَقْ" أي يصطنع المشاكل. اليوم نصف الشخص الأنيق ظريف الملبس بأنه (عايق) كما نصف المرأة حسنة الهندام بأنها (عايقة) رغم أن هذا الاسم كانت تلقب به المرأة التي تدير بيتًا للأعمال المنافية للآداب، وظلت الكلمة فيما يبدو متداولة بهذا المعنى حتى النصف الأول من القرن العشرين كما يظهر لنا على سبيل المثال من مجموعة قصصية تحمل عنوان (مذكرات فتوة) كتبها الأديب والصحفي المصري حسني يوسف بالعامية المصرية ونشرت في جريدة لسان الشعب التي كان يملكها ويحررها بنفسه، ثم صدرت في كتاب عام ١٩٣١م. ويتحدث فيها الفتوة عن امرأة قابلها بالصدفة في القاهرة ويصفها بأنها: "أتاريها عايقة في طنطا"، ونفهم من السياق كونها قوادة تحاول استعادة إحدى فتياتها اللاتي يعملن تحت إمرتها في هذه الأعمال، وهي دون شك كانت يومًا في شبابها تمارس نفس الرذائل.
مثال آخر وهو اسم الحرافيش الذي جعل له الأديب الكبير نجيب محفوظ قيمة عالية وتقديرًا دوليًا عندما كتب روايته الشهيرة (الحرافيش) كما أطلق الاسم على جماعة الحرافيش التي كانت تضمه مع مجموعة من أهم الأدباء والفنانين والمثقفين المصريين، فإذا عدنا لأصل الكلمة وجدنا أصلها كما ذكر الفنان أحمد مظهر، أحد أعضائها البارزين، في لقاء قديم على التليفزيون المصري؛ كلمتين: (حارة)، و (فيش) أو (مفيش)، والحارة في الماضي اسم يشار به إلى الحي أو مجموعة منازل متلاصقة بينها طريق أو عدة طرق ضيقة ويسكنها عادة مجموعة متآلفة من الناس المتعاونين على الحلوة والمُرَّة، لذلك فكلمة حرافيش تعني هؤلاء الذين لا حارة لهم، أي المنبوذين واللقطاء وعديمي الأصل، وقل ما تريد في معنى الكلمة التي تحولت حديثًا من وصمة عار إلى صفة فخر.
مما سبق نجد أن الأدب والفن العربي والمصري خاصة لم يجد عبر التاريخ ضيرًا في حكايات اللصوص والصعاليك، بل جعل منهم رواةُ القصص والحكواتية والشعراءُ الشعبيون أبطالًا قوميين يندمج المتلقي معهم، وينظرُ نظرةَ إجلال وتقدير لملاعيبهم وحيلهم؛ يصفق تشجيعًا للراوي ليحثه على استكمال حكايته لملعوب جديد من (ملاعيب شيحة) أو (سيرة علي الزيبق) أو (دليلة المحتالة) و ابنتها (زينب النصابة)، أو (أحمد الدنف) الذي يقال إنه كان سفاحًا أعدم في مصر، ويقيم المصريون مولدًا لشيخ يحمل نفس الاسم يعقد في منطقة الإمام الشافعي من ٣ إلى ١٠ شعبان كل عام، والله أعلم إن كان هو نفسه من أصبح يعامل كالأولياء والقديسين.
إذن فعبر تاريخنا الأدبي والفني وتراثنا الثقافي الشعبي لم يكن هناك ضير من وجود شخصية اللص أو المحتال، بل لم يُنظر لصفة هؤلاء بعين اللوم كما لم تستوجب أفعالهم خزيًا أو عارًا؛ على العكس اعتبروا أبطالًا عند البسطاء وقدوة تحتذى، ولا يغيب عنا شخصية شعبية شهيرة وهو أبو فن المربعات (ابن عروس) الذي لا يعرف أحد إن كان شخصية حقيقية أم اعتبارية لكن قصته في كل الحالات صاغها الضمير الشعبي وجعله رمزًا للحكمة وفي نفس الوقت كان قاطع طريق ومجرمًا وزعيم عصابة. ومثله أيضًا الشاعر المفصح الذي يقول عنه (شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي) في كتابه (المستطرف في كل فن مستظرف) إنه كان لصًا فاتكًا، وينقل من شعره قوله:
"وإني لأستحيي من الله أن أُرى أجرجر حبلي ليس فيه بعير
وأن أسأل المرء الدنيء بعيره وأجمال ربي في البلاد كثير"
فهو إذن يبرر اللصوصية بالشعر والفن والظرف، ويعتبر سرقته للجِمال حياء من الله وعزة نفس تمنعه من أن يسأل شخصًا دنيئًا أن يقرضه بعيره، فهو بدلًا من ذلك يسرقه!
هنا نأتي لسؤالنا بصدد شخصية النشال؛ لماذا رفض المصريون مشروع (مجرد مشروع) فيلم كان سيقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي يتناول قصة حول نشال مصري، وفي نفس الوقت تقبل نفس الجمهور شخصية النشال في مسلسل (النُص) دون أن يجدوا غضاضة في ذلك؟!
الإجابة قد تكون بسيطة إلى حد كبير؛ أولا بالنسبة لنشال أحمد حلمي: هل كان يصلح بطلا شعبيًا! بالتأكيد لا لعدة أسباب أولها أن اللص الذي يختاره العوام ليمثلهم ليس أي لص، لكنه لص بمواصفات خاصة، لص طيب، لص يقاوم الأشرار الذين هم بالأساس علية المجتمع ورموزه وسلاطينه. ينتقم من ظلمهم للفقراء ومن استغلالهم لسلطانهم ونفوذهم لقهر هذه الجماهير وسرقة أقواتها، إنه لص يؤمن كما يقول الدكتور فاروق خورشيد بأن "ما أخذ بالسرقة لا يسترد إلا بالسرقة". إنه يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويقيم العدل الذي غاب ويتكرر غيابه في عصور الاضمحلال والخراب والتراجع، عصور الهزيمة والانقسام. هذا هو البطل الشعبي الذي لم يظن المواطن المصري -خاصة المثقفون- أن نشال أحمد حلمي قد يكونه، النشال الذي سيظهر في فيلم من إنتاج مموِّل غير مصري. منتج يؤمن أن الهدف من الفن الترفيه. الضحك من أجل الضحك. كما أن قصة الفيلم المعلنة تتحدث عن مصري ينشل الحجاج في الأراضي المقدسة. دناءة ما بعدها دناءة، ووصمة عار تلحق بالشخصية المصرية لا يمكن للجمهور المصري التسامح إزاءها خاصة إذا وضعنا في الاعتبار المجالدات التي وقعت وتقع بين المنتج السعودي والجمهور المصري في مجال كرة القدم والتي جعلت الجمهور متربصًا له وغير قابل لتصور حسن النية من جهته حتى يثبت العكس.
في الطرف المقابل نجد أحمد أمين -مع صناع مسلسله- ينطلق من فهم عميق لشخصية البطل الشعبي. فهم ليس جديدًا عليه فقد عرفه الجمهور به منذ ظهوره وصعود نجمه ببطء لكن بثبات. كان دائما ذلك الفنان المثقف وليس النجم (السلعة التجارية). قدم كوميديا محترمة بعيدًا عن الشائع من كوميديا (زغزغة الجمهور) التي قد تُضحك لكنها لا ترسخ في الذهن ولا تحفز العقل ولا تتفاعل مع الجمهور أو يتفاعل معها باستثناء لحظات القهقهة التي يغيب فيها العقل، وبالمناسبة هذا ليس بعيدًا عن تاريخ أحمد حلمي مع الجمهور، إلا أن الأخير بدأ جمهوره يحس بخيانته لتاريخه وخضوعه لبريق النجومية أو إغراء المال فانقلب عليه، وجمهور السينما والدراما قاسٍ في مواقفه خاصة وهو يتمتع بذاكرة قوية لا تغفر الزلات بسهولة.
شخصية النشال في مسلسل (النُص) مناسبة تمامًا ليكون بطلًا شعبيًا، وتم بناؤها بعناية ووعي ليس أدل عليه من أن المسلسل اكتفى من كتاب (مذكرات نشال) المأخوذ عنه والذي ألفه في عشرينيات القرن الماضي الصحفي (حسين يوسف) بالخطوط العامة فقط مثل أسماء الشخصيات وبدايات ظهور كل منهم وعلاقاتهم معًا. أما في التفاصيل وفيما وصلت إليه الشخصيات فقد أطلقوا لخيالهم العنان ليحولوا عبدالعزيز النص وعصابته من مجرد لصوص ومحتالين إلى جماعة وطنية باختلاف بسيط عن المجموعات الثورية وهي أنهم يلاعبون الإنجليز، لا يقومون بعمليات فدائية لكنهم يشنون هجمات شبه انتحارية تسخر وتُمَسخر المحتل وتجعله مُسْخَة هُزُؤًا أضحوكة للخلق.
الزمن الذي تدور فيه القصة رشح العمل أيضًا للنجاح. بعد الحرب العالمية الأولى في زمن أزمة اقتصادية ضربت المجتمع المصري والعالم أجمع، انتشرت أوبئة. هبط تقييم كثير من أسر الطبقة الوسطى، وصعد آخرون من أدنى طبقات المجتمع من الغجر والنَّوَر والحَوَش ليحتلوا مكانة عليا بما اكتسبوه من أموال نتيجة التعاون مع جيش المحتل أو الأعمال الدنيئة كالاحتيال والسرقة والترفيه والقتل أحيانًا، صعدوا بثقافتهم الدنيا وقيمهم المرتبكة ومعاييرهم الانتهازية. زمن فيه كل ما ينبه المثقف القلق دائمًا والذي يشعر بالمسؤولية تجاه أهله ووطنه، القلق الإيجابي الذي يتواصل من خلاله مشاهد اليوم مع قصة حدثت أو ألفت في الماضي ويشعر أنها تخاطب مخاوفه الحالية وتشير إلى أزماته التي يمر بها بشكل فني.
من ناحية أخرى تتيح هذه البيئة الزمانية والمكانية التي يدور فيها المسلسل لصناعه مساحة كبيرة للإجادة في الديكورات والاكسسوارات والإضاءة والملابس، كما تفتح المجال لخيال المتلقي الذي لم يعش بالتأكيد في هذا العصر ومع ذلك فهو غير بعيد للغاية عنه.
النشال عبدالعزيز النص، هو نموذج مثالي للبطل الشعبي؛ لص ظريف مثل (آرسين لوبين)، حرامي شريف مثل (روبن هود)، وخارج عن القانون ليس لكونه همجيًا بل على العكس يحاول تحقيق العدالة الغائبة والانتقام من الكبار الظالمين المتجبرين. مثله في ذلك مثل (علي الزيبق) و(أدهم الشرقاوي). نشال، صحيح؛ لكنه يحمل صفات بإمكان المتلقي قبولها وعدم اعتبارها مشينة بل اتخاذه قدوة، وهو ما لم يكن في اعتقاد الجمهور المصري إمكانية أن تكون عليه شخصية نشال أحمد حلمي الذي لا يسرق الحقوق ويعيدها للطيبين، بل هو يسرق الطيبين أنفسهم كي يُقهقه السفهاء.
أحمد صلاح الدين طه
٤ أبريل ٢٠٢٥م.
dedalum.info@gmail.com